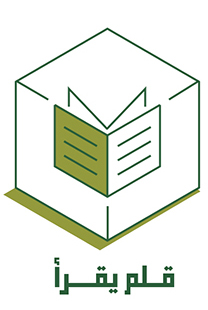أبي الذي أكره: التعافي من إساءات الأبوين- 1

أبي الذي أكره
بقلم: د. عماد رشاد عثمان
السجن
"بعض الآباء يدمرون أبناءهم قبل أن يدمرهم أي شيء آخر"
جيم موريسون
كانت أصواتهم تطل من وراء قضبان السجن كل زنزانة لها ذائقة خاصة، لها بصمة الجُرم، ولكنهم كانوا جميعًا أبرياء.
وذلك كان سجنهم الحقيقي (سجن الجُرم الذي لم يرتكبوه)، ولكنهم تشربوه وصار يكبلهم ويقيدهم ويمنعهم من تحقيق ذواتهم.
لم يكونوا يدركون أن أبواب الزنازين مفتوحة، وأن بإمكانهم الفرار، ولكنهم ألفوا هذه الزنازين ولم يتصوروا يومًا أن بالإمكان الهرب، وأن هناك حياة خارج الزنزانة.
كيف وقد صنع الزنزانةَ أحباؤهم.. آباء وأمهات، أو أعمام وخالات، أو معلمون ومشايخ وقساوسة ورموز مجتمعية، صنعت لهم الزنازين باسم الحب أو المصلحة.
حتى قرر أحدهم يومًا أن يتجرأ ويدفع الباب قليلًا لينفرج، ويدخل بصيص من نور التعافي، ثم تجاسر أكثر وخرج للممر هناك حيث زنازين الألم، ثم جازف أكثر وصاح في المحبوسين أن هناك نورًا خارج الأقفاص، وأن الحياة خارج السجن ممكنة ومكفولة وليست محرَّمة عليهم!
وحينها فُتحت الأبواب ببطء، وخرج الحبيسون، ليلتقوا هناك في الطريق إلى الطريق، في رحلة الهروب خارج السجن.. السجن الناعم!
وفي ذلك الممر نقشوا حكاياهم وكتبوا قصصهم على الجدران، وأعلنوا كيف الهرب لكل من ألقته أقداره يومًا في سجن كهذا، ومن تلك النقوش كان هذا الكتاب.
زنزانة 1
"يظن الآباء أنهم بصفعاتهم يؤهلوننا لعالمٍ قاسٍ لن يربت على ظهورنا، لا يدرون أن ربتاتهم الغائبة هي ما كانت ستؤهلنا لقسوته، وأن صفعاتهم لم تصنع فينا سوى أن منحت الخوف وطنًا داخل نفوسنا!
وهناك وراء صراخ أبي الدائم، وحزامه الذي يترك علاماته كسوط على جلدي وانتهاره الذي لا ينقطع؛ استوطنني الخوف ولم يبارحني يومًا..
كنت خائفًا على الدوام، فردَّات أفعاله لم تكن متوقعة قط، كان يغضب لأقل الأشياء ولا تتناسب غضبته أبدًا مع جُرمي، كنت أحيا دائم التأهُّب، دائم الترقُّب، مهدد على الدوام.. يفزعني صوته في الخارج، يفزعني نداؤه لاسمي حتى لو اتضح أنه كان نداءً عاديًّا.
لم يزل حتى اللحظة يفزعني اتصاله الهاتفي؛ ظهور رقمه على هاتفي يمنحني رعدة خوف "رباه ماذا فعلت الآن؟"، "أي مصيبة يحملها اتصاله؟"..
كان يظن أنه بهذا ينشئ رجلًا ويقوي ظهره ويمنح جلدي خشونة لازمة، ولم يمنحني سوى قشرة رجولة ظاهرية تخفي وراءها طفلًا خائفًا متأهبًا يمد عينيه دومًا ناحية صوت خافت لا يمثل خطرًا ولكنه يتوقعه وحشًا!
صار العالم في عيني مكانًا موحشًا مقفرًا مثيرًا للخوف ينتظر غفلتي لينقضَّ عليَّ لالتهامي".
![]()
زنزانة 2
"أما أنا فلم يكن والداي يسيئان معاملتي، بل الحياة هي من كانت تسيء معاملتهما.. كان لديهما من الثقل والألم والمعاناة ما يجعلهما شديدي التهجم دومًا..
أبي طالما كان مرهقًا كئيبًا شاردًا يلعن الدنيا.. وأمي كانت حزينة دومًا لا تكاد عيناها تخلوان من دمعة تلمع.
لا أتذكر أني شاهدت أحدهما يضحك يومًا، ولا أدري هل كانت الظروف صعبة لتلك الدرجة أم أنها تلك هي العدسة التي يريان من خلالها العالم.
المهم أني قد نشأت أشعر أن هذا العالم كئيب ومتجهم، وأنه سيحط بثقله علينا ما أن نبلغ الرشد ونواجهه.
صار الحزن هو اللغة التي أفهمها من المشاعر، وحتى هذه اللحظة لا أظن أني أتقن التعامل مع الفرح، أو أنني أتمكن من استقبال مشاعر كالامتنان أو البهجة أو المرح.
ولكن لم تكن تلك هي المشكلة فقط، والتي جعلتني مدمنة للحزن أقوم بتعريف نفسي من خلال الأسى والشكوى والألم فقط.. بل كانت المشكلة الثانية هي شعوري بأن أبويّ لا ينقصهما همي، بأنه دومًا كان لديهما ما يكفي ويفيض لئلا أنوء بحملي لديهما.
لذا قررت في هذه الحياة أن أكون ضيفًا خفيفًا، وتعلمت أنه لا مساحة مكفولة لمشاعري، وأن ما لدي ينبغي إخفاؤه، وأن حزني الدائم يجب أن ألوكه في صمت وخفاء، وأن من حق كل شخص في الحياة أن يشعر ويطلب ويحس.. إلا أناّ!
مشاعري لم تعد عبئًا عليَّ فقط؛ بل عبئًا فائضًا على الجميع.
"كل واحد فيه اللي مكفيه" كانت تلك قاعدتي، لذا ينبغي عليَّ أن أستر مشاعري وأواري احتياجي وأدفن رغباتي لئلَّا أثقل عليهم أكثر!
صار دوري في الحياة مجرد (سنيدة) لأشخاص يمارسون أدوار البطولة، ولكني كنت سنيدة في حكايتي أيضًا وسمحت لأشخاص غيري أن يكونوا أبطال حكايتي الخاصة، وأن يكون لهم السيادة والتحكم في دنياي أنا!
فلا عجب أن أتزوج في النهاية رجلًا لا يرى بالكون سوى نفسه، فتلك هي المساحة المثالية لممارسة التخفي والتخفيف!
ولا عجب أن تستنزفني صديقتي يومًا حتى لم يعد لديَّ ما يكفي من الطاقة لأصادق أحدًا بعدما رحلت!
بل لا عجب أن أجد صعوبة كبرى دهرًا في أن أصيغ انفعالاتي أو أدرك ما الذي يمرُّ بحواسي الداخلية في تلك اللحظة!
كنت وكأنني أعاني من (أمِّية انفعالية)، أو كأن مشاعري تتحدث لغة غير لغتي لا أتمكن من فهمها أو نقلها أو التعبير عنها، وهو ما جعل عملية التشافي في بدايتها مرهقة للغاية؛ لأنني للمرة الأولى أشعر بأنه مسموح لي أن أنظر إلى الداخل وأخبر شخصًا آخر ما الذي أجده دون أن أشعر بأنني ظل ثقيل تمَّ إلقاؤه على حياته".
![]()
زنزانة 3
"أبي كان غائبًا.. وهل يمكن للغيبة أن تُعدُّ جُرمًا؟!
لا أحَمَّله مسؤولية ألمي ولا أعتبره رجلًا مؤذيًا فقط لأنه كان غائبًا دائم السفر بحثًا عن كفالة حياة طيبة لأبنائه.. كان ضيفًا على بيتنا نراه كل عام لما يقل عن الشهر، نرتدي له أحسن الثياب وأحسن الأخلاق، نتزين لأبي كغريب يعبر بحياتنا.. حياتنا التي كان يتم التأكيد دومًا أنها مدينة له بالوجود، كان وجودي بأسره مدينًا لرجل غريب يدعونه أبي!
يقولون إن الأب هو الذي ينادي على الذكر داخل ابنه ويمنحه الفرصة للنمو، وإن وجود الأب وحسن العلاقة به ضرورة تكوينية للذكر الشاب، وعبر المحاكاة والتطابق مع الأب يجد الشاب الناشئ منا ملامح ذكورته ويتمكن من استيعاب دوره وتعريف ذاته.
لذا فغيبة الأب ليست مجرد فقد للمحبة، إنما تحمل نوعًا من فقد الذات.. افتقاد لعامل مهم في تكوين معادلة الرجولة الخاصة بالذكر.. جرح غيبة الأب له أثر الشعور بالنقص المتغلغل في أقصى بقاع ذكورتنا!
ولكن لم تكن تلك هي المشكلة الوحيدة، ولكن كانت علاقتي مع الأم المُحبَطة.. الأم المفتقدة لزوجها والتي قررت بشكل ما أن تتخذني زوجًا بديلًا، فترقيني إلى مقام الزوجية النفسية، فتعاملني كشريك وحبيب لا كطفل وابن ينمو..
ذلك الحب المهووس حد إصابتي بالحيرة، وتلك الغيرة المتفاقمة والمحاولة الدائمة للسيطرة على حياتي هوسًا بمصلحتي!
كيف يمكن أن تنشأ استقلالية رجل في بيت يحمل أبًا غائبًا وأمًّا مهووسة بالسيطرة!
لا عجب أن يتحول لمشروع (ابن أمه)... لعبة الأم التي تسعى دومًا لتنميقها.
مشروع الرجل المثالي لامرأة محبَطة تنفذه على ابنها، فتقصص ريش تحليقه وتقلَّم أظفار ذكورته، وتمارس عليه إخصاءً ممنهجًا. لا واعيًا. لكل نوازع التمرد الطبيعي فيه.
وهكذا كانت حياتي بأسرها بحثًا عن الأب الغائب الذي أحاول أن أنظر إليه استلهامًا لأتعرف على ذاتي، وهربًا من محاولات أمي الخانقة لوأد ذكورتي تنفيسًا لإحباطها الدفين.
أتحسس قلبي فلا أجد غير الشك في الذات والتردد والخوف وعدم القدرة على اتخاذ القرار.. أي قرار!".
![]()
زنزانة 4
"كل شيء يصدر مني هو ناقص من زاوية ما.. تلك هي قصتي لا أكثر.
لم أكن قط في عين أبي كافية، ولم أكن قط على المستوى المطلوب بعين أمي، عشتُ زمنًا لا أريد سوى نظرة فخر واحدة تتسلل من عين أحدهما..
لم يُمارس تجاهي الإيذاء الجسدي أو اللفظي، لم يكن هناك سباب أو نزاع أو طول صراع؛ إنما فقط التركيز الدائم والذي لا ينقطع عما لم أحققه.
يظنون أنه من التشجيع حين أحصل على تسعين بالمائة هو التركيز على العشرة الناقصة لا التسعين المحققة.
يظنون أن المقارنات بفلانة وفلانة يمكن أن تحفزني وتدفعني لمزيد من بذل الجهد.. ولم تكن تفعل سوى أن تعمق داخلي مشاعر الدونية.
ثم اندهش أبي حين علم إصابتي بالوسواس القهري سعيًا نحو كمالية لم أستطع يومًا نيلها فقط حيازةً لرضاه ورضاها! وسواس ينهشني كل يوم حين يهمس لي كما تعودت يومًا: (كل شيء تفعلينه ناقصًا، وكل نقص هو دنس، وكل دنس ينبغي التطهر منه، لن تكوني أبدًا على المستوى المطلوب)".
زنزانة 5
"يخبرني أصدقائي وكل من يعرفني أنني (أوڨر).. فتاة درامية هستيرية مبالغة في مشاعري (دراما كوين). ينقدني الجميع قائلين إني (أهوِّل) و(أبالغ) و(أفاقم الأمور) و(بعمل من الحبة قبة)..
ولكن أين العجب! فلم تكن مشاعري يومًا مقدرة.. ابتداءً من تهكمات أبي على بكائي الطفولي صغيرةً، وسخرية أخي الأكبر من مسببات حزني، وصمت أمي الدائم بيننا، لم تكن لمشاعري مساحة في البقاء، ولم أشعر يومًا أن إحساسي منظور أو مرئي، فماذا أفعل؟!
بالغت في ردَّات أفعالي لعلهم يفسحون لها المجال، ومنحت مشاعري بُعدًا دراميًّا مسرحيًّا بإفراط لعلها تصبح مرئية أو مقدرة أو يتم اعتبارها يومًا هناك.
وحينها فقط كانوا ينظرون إليَّ، لم يكونوا يرونني إلا في نوبات الهستيرية، لم يكن صوتي مسموعًا إلا في حالة الصراخ، ولم يكن وجودي مقدرًا إلا في نوبات التحطيم والانتحاب، حينها فقط كانوا ينصتون جميعًا.
لذا لا غرابة أن تصبح تلك هي لغة مشاعري، وتلك هي طرائق ترجمة انفعالاتي؛ فإن انفعالي الاعتيادي لا يتم إقراره أو المصادقة عليه أو تفهمَّه ما لم يحمل بُعدًا كارثيًا ويشكل تهديدًا صارمًا وصادقًا لهم".
![]()
زنزانة 6
"دومًا أشعر بأنني لا ألتئم مع الجموع، وكأنه ليس لي مكان بينها كقطعة (بازل) ليست من تلك الأحجية وإنما تم تغليفها خطأ داخل تلك العلبة؛ علبة الوجود.
كانت حياتي تلخص لي كيف تحاول قطعة (البازل) أن تجد لها مكانًا ما يلائمها ولو ادِّعاءً!
وجدت نفسي أصبحت شخصًا إرضائيًّا.. أسعى فقط للتمثل بما يريده الآخرون.
أصبحتُ كائنًا ممزقًا بين ما أراده كل شخص ذي قيمة عبر بحياتي.. لا أستطيع أن أعبر عن نفسي أنا، أو أبحث عن الأحجية الخاصة التي أمثل فيها القطعة الناقصة.
لطالما سعيت للانتماء.. وفي سبيل الشعور بالانتماء قدمت كل الأثمان الممكنة.. كنت مهووسًا بمساعدة كل شخص.. كنت (صاحب صاحبه) ومثلت طويلًا دور (الصديق الرجولة) الذي يظهر دومًا في كل ضائقة ويبذل نفسه رخاءً وشدة.
فقط لأشعر ولو للحظة وحيدة أن لي موقفًا ما في هذا الكون.
بدأت حكايتي هناك حين قرر أبواي الانفصال، وأن ينطلق كل منهما على الطريق مرة أخرى ويجرب حظه في زيجة جديدة.
كنت غريبًا في بيت كل منهما.. لم أشعر أن أيهما بيتي.
وجدت حينها نفسي غريبًا وعصيًّا على الالتئام أيضًا في تلك البيئة الجديدة.
كان أبواي يبدوان بالنسبة لي وكأنهما تبنياني وليسا البيولوجيين، كنت ضيفًا على كلًّ منهما.
ربما يوم حدث ما حدث وبلا وعي شعرت بأن ذلك الانفصال كان بسببي.. تساءلت هل كنت عبئًّا لتلك الدرجة...!
قررت أن أسعى للالتئام.. قررت ألا أكون عبئًّا؛ بأن أكون تمامًا على هواهما.
فصرت الصبي المطيع.. الهادئ.. المعطاء.. الذي لا يصنع المشكلات ولا يثير الشغب.
تنازلت عن كل فكرة وحركة ورغبة يمكن أن تثير أي شيء.
تنازلت عن نفسي لألتئم هناك في كل بيتٍ منهما، لئلا أكون ثقيلًا؛ بل داعمًا ومريحًا.
ولكني نسيت نفسي في تلك الأثناء لأجد نفسي أتنازل عن نفسي في كل مساحة أخرى من الحياة، وأخطو نحو العالم الخارجي أتلمس الأُلفة، فأقدم نفسي قربانًا لهذا الشعور بالانتماء.. أرضي الجميع وأحاول ألا أكون عبئًا.. أحاول أن أساعد وأدعم وأنقذ وأساند.. فقط لأشعر أن لي مكانًا ما في هذا العالم.
لعل هذا العالم يفسح لي ولو مساحة ضيقة لأوجد، ولئلَّا يهجرني ثانية".
![]()
زنزانة 7
كرهت جسمي وأنوثتي.. فأنا دومًا بين وصمة (العورة) وبين وصمة (القُبح)؛ أنا فتاة إن تغطت فهي في عين أبيها قبيحة، وفي عين أمها سمينة حد التقزز، وإن تعرى مني جزء ذات غفلة فأنا العورة المتعمدة إثارة الفتنة الباحثة عن لهاث الرجال اشتهاءً!
كنت دومًا متهمة؛ إن تأخرت رأيت نظرة الشك في العيون، وإن تحدثت هاتفيًّا رأيت ظلًّا يتنصت وراء الباب!
علمت أن الأنوثة قنبلة موقوتة، وأن جسدي خطرًا مفخخًّا!
كرهت جسمي قبيحًا وجميلًا على السواء!
![]()
زنزانة 8
"تلقيت الدين من أبي؛ أبي الشيخ العلامة، المنظور من الجموع، المسؤول عن رعيته ونجاتهم، المهووس بالأحوط دومًا، والذي يعالج الأسئلة بقمع غريزة التساؤل!
وقد أصابتني ربكة عظيمة في تصوري عن الله، لم تستطع دروس العقيدة أن تشفيها.
وجدت أنني في النهاية أستمدها بشكل نفسي لا بشكل روحي من تصوري عن أبي وتقلباته العنيفة في معاملتي.
فأحيانًا أرى الله كقوة سارية في الكون غير منفصلة عنه، كنسيجٍ يحكم بنية الكون.
وأحيانًا أخرى أشعر أن الله هو قوة منفصلة عن الكون، وحشية، متأهبة دومًا للانتقام مني..
وأحيانًا أراه قوة رحيمة معتنية لها خطة في حياتي، خطة تقتضي الأصلح لي دومًا، حين أراه حنونًّا محبًّا للبشر، ويحبني بشكل مخصوص حبًّا غير مشروط، يهتم لأمري، ويكترث باحتياجاتي.
وأحيانًّا أرى الله ككيان قاسٍ للغاية أو أقرب للسادية لا يحب سوى من كانوا بالمواصفات القياسية ومن كانوا تمامًا على المقاس مما يطلبه.
لقد سرق أبي مني الله، حين بالغ في تنزيهه حتى فصله عني طفلًا فلم أفهمه، وأفرط في تعداد وصاياه حتى عزله في بقعة لا يصل إليها أحد، وتوسع في التخويف منه حتى امتلأت المسالك نحوه بأشواك الذنب واللوم، فصرت أرى نفسي في عينه مقصرًا وغير جدير بمحبته ولا مستحق لقربه.
صارت العلاقة مع الله تعريني وترهقني وتكشف لي عن مشاعري الدونية وعدم الاستحقاق.
صار الله سجين المواسم، وصرت حبيس استنادٍ لا يُلبِّى وإلزامات واشتراطاتٍ لا سبيل لي بالوفاء بها.
قد صار الله عبئًا علي؛ وأضحى الدين قيدًا يدميني، بعدما كان من المفترض أن ألقي بالأعباء إليه وأتحرز من قيودي بكلمته.
لم أكن أملك حق الحديث عن الله، فهو حق مكفول فقط لذوي الحظوة من سدنة الصنم المنحوت معنويًا له وعلى رأسهم أبي.
أصبح الحديث عن الله منطقة محظورة نمنع دخولها لغير العاملين!
سرق مني أبي الحق في التساؤل، والحق في الشك، والحق في الحيرة، والحق في التوهة!
فماذا أفعل في توهتي وحيرتي وشكوكي، وأين أذهب بها إن كان الرب يضيق بالمتشككين!
قد كنت أمضغ غربتي بين صنوف عدة ممن حولنا من مريدي أبي وتلاميذه وإخوانه من أهل اليقين المطلق والإيمان القويم، والاعتقاد الصافي من الدَخن!
أوارى تساؤلاتي وأمارس الشك في إبحارٍ مستخف على الإنترنت لدى أولئك الذين يمتلكون من الشجاعة ما يكفي ليجاهروا بتوهتهم البشرية!
ثم أشارك أبي في صلبهم ولعنهم بالعلن!
كنت أتعمد أن أعرف عمن يصمهم بوصمات (الضال المضل)، ومن يكتب عنهم تحذير من ضلالات (فلان)، ومن يشنع بهم على المنبر ويصفهم بالمبتدعة والزنادقة والمارقين، فأدلف إلى عالمي السري لأتابع حكاياهم، وخروجهم عن المألوف.
لقد كانوا يمثلون لي الخروج عن سطوة أبي، فصاروا جميعًا أبطالي!
لم أستطع يومًا أن أصير ملائمًا للمواصفات القياسية لأبي الذي يوهمني أنه يعمل وكيلًا حصريًا للرب على الأرض؛ لم نستطع استرضاء الرعاة الرسميين للحقيقة الكونية!
ولكنني وجدت الله نفسه يمد يديه نحوي بغرابة، ويلقي بروحي بعض الشجاعة؛ الشجاعة لأنخلع؛ الشجاعة لأبتعد!
الشجاعة لأستكشف مساحات أخرى لم أعتدها!
وكأن صوت الرب كان بمثابة أبٍ بديل رفيق ينادي ستبقى أبنًا لي أينما حللت!
فألتجئ للرب نفسه طلبًا للعون لأتمكن من خوض التوهة متسلحًا بالشعور بأنني مقبول في عين الرب لا كما يخبرونني ويخبرني صوت أبي داخل نفسي أني منبوذ ملفوظ وأن عافيتي محض إمهال.
طلبًا للعون على الحيرة؛ لا طلبًا للخروج عنها بل طلبًا للعون على استكشاف نفسي فيها.
طلبًا للحق في الغضب، والحق في الرفض، والحق في المسير طوعًا لا بسلاسل الذنب والخوف!
طلبًا للإذن بالمسير في رحلة إنقاذ؛ إنقاذ لصورة الله الحقيقية النافقة داخلي.
طلبًا للإذن بكسر الحاجز الصخري الذي يعزلني عنه والذي علقت عليه مقاييس أبي ومعاييره ووصاياه!
ولكني لا أزال أشعر أنني أنتظر عقوبة ما تلاحقني وعما قليل تدركني.
عقوبة على أي شيء؟
لا أدري.. ربما شيء قد نسيته!
وربما فقط عقوبة عليّ؛ على تكويني، وعلى وجودي.
أسير وكأن وجودي خطأ ما تسعى الحياة لتداركه، وكأنني الخطأ الهارب من محاولة صاحبه تصحيحه!
وليس ذلك بالشعور المريح على الإطلاق...
![]()
زنزانة 9
إن كل آلامي نبتت هناك حول الجنس.
قد أنتهكني يومًا تحرش خالي منذ كان عمري ثماني سنوات وأنهكني مستمرًّا لأعوام عديدة، سري الصغير الذي أواريه عن أعين المتلفتين عن أعمق نقطة من وجيعتي، وأخفيه عن ملاحظة المندهشين لتوجسي من الرجال.
ذاك الشعور بالدنس فوق خلاياي، وكأن جسده الشره لم يزل ملتصقًا بي، وكأن يده لم تزل تمس جلدي من لحظتها!
وكأنني لا أزال تلك الصغيرة الخائفة التي ألجمتها الرهبة، وجمدتها الحيرة!
الشعور بالدنس يومًا وراء يوم ولمسة تلو الأخرى كان يتوغل أكثر!
فحفرت في صدري حفرة عميقة دفنت فيها سري وجاهدت طويلًا لأواري رعشتي.. وأخبئ رجفتي، وأصنع قشرة صلبة أواجه بها الكون. تحاول المرأة مني أن تقي الطفلة الصغيرة الهشة داخلي من أي سطو جديد محتمل، فأبتعد خائفة من كل اقتراب، وبقيت الصغيرة داخلي وراء الأسوار التي ترتفع أكثر عامًا بعد عام، متأهبة شديدة الحذر، أعلن حالة الطوارئ النفسية القصوى أمام الحميمية، وحالة النفير الجواني العام في لحظات الحب والانجراف، وفي مواقيت القرب والانكشاف!
لطالما شعرت أنني نفس المتجمدة من الفزع لحظة امتداد يد خالي تحت ملابسي.
تعثرت كثيرًا في علاقتي بالسماء، فقد كنت أخفي وراء عفتي لومًا مستترًا لله لم أدركه.
وقد كرهت كل مثالية، ولم أعد أصدق أحدًا وأنا أتذكر خالي بوجهه الصبوح وتدينه الظاهري، ولعابه الخفي، ويلاحقني هدير أنفاسه اللاهثة كضبع جائع جوار وجهي.
تساءلت كثيرًا لماذا أخفيت الأمر؟
وكأن مساحة متوهمة من نفسي أوحت إلي بأنني شريكة في الجُرم، خشيت ردة فعل أبي وأمي إن رويته.
وحين يغيب شعوري بالمشاركة، كان ينتابني غضب على ذاتي متسائلة لماذا لم أمنعه؟ لماذا لم أرفض!
ولكن كل شيء قد تغير حين تحدثت نافضة هذا التوجس والتخوف، حين صرخت بالرفض.
"لا أقبل. أن ينتهكني المؤذي مرتين"
مرة يوم أن مد يديه تحت ملابسي طفلة..
ومرة ثانية يوم أن بقي داخلي كذكرى وحشية تنغص علي حياتي، وتقف حائلًا أمام سلامي النفسي وحصولي على أبسط حقوق الآدمية!
كيف يتوارى من لا شيء فيه.. وكيف أخجل ولا ذنب لي!
قد بقيت الذكرى عالقة طويلًا هكذا ولم تسقط في جوف النسيان، مع كل محاولاتي للتناسي والتلاهي؟!
حتى علمت أن للبوح هذه القدرة الشفائية!
![]()
"أنا لست ما حدث لي، إنما أنا ما اخترت أن أكونه بالرغم من ذلك"
كارل جوستاف يونج
إننا لن نخوض تفصيلًا في أشكال الإيذاء ومظاهر الإساءات قدر حديثنا عما تحدثه فينا الإساءة ومظاهر التكوين الشائه الناجم عنها، ولكن تمثيلًا لا تفصيلًا نذكر بعضًا من أشكال الإساءات:
الإساءات البدنية: مثل الضرب والصفع واللكم، ويروي الكثير عن (الربط والتكتيف)، ويروي البعض عن (التحريق) وغيرها من أشكال اختراق المساحة الجسدية للأبناء توبيخًا.
الإساءة النفسية:
* مثل المقارنات بالأقران وأفراد العائلة وربما إخوة الطفل نفسه.
* الطرد أو التهديد بالطرد.
* الإهمال، والتجاهل، وعدم الاكتراث بالطفل واحتياجاته.
* التفرقة بين الطفل وإخوته، أو التفرقة بين الأبناء على أساس امتيازات الجنس (امتيازات الذكور) أو العمر (الطفل البكر)، أو منح الابن الذكر مساحة سلطوية وتحكمية بأخواته من الإناث.
* الألقاب المهينة: كأن يتم إطلاق اسم أو كناية على الطفل متعلقة بسلوكه أو تكوينه، ويتم مناداته بها تعزيزًا أو تأديبًا.
* التنمر: ربما حينًا بدوام التهكم والإنهاك النفسي للطفل بالسخرية أو الاستفزاز، أو التعليق على ملامحه (كلون بشرته أو وزنه أو قسمات وجهه أو بعض أعضاء جسده انتقاصًا).
* محاولة كبت مشاعر الأطفال وعدم تقديرها.
* صراع الأبوين على مرأى ومسمع الأبناء بما يتضمنه من إهانات وفجر في الخصومة.
* إجبار الأبناء على الانحياز لأحد الأطراف المتصارعة في العائلة.
* التركيز على الجوانب السلبية من الأبناء، وغياب التشجيع والتقدير والحفاوة.
* كثرة السباب ودوام التقبيح والانتهار، وكثرة الصياح والصراخ ونوبات الغضب التي يتم إنفاذها في الطفل أو أمامه.
* التسلط المفرط، وقمع مساحات الاختيار، والتهديد بالحرمان، ودوام المن بالإنفاق.
* التخويف: بصص العفاريت، أو التأديب بالترويع (حجيبلك الغول أو ما شابه).
* خذلان الوعود المتكرر.
* الحماية المفرطة، والتدليل المبالغ فيه.
الإساءة الروحية: عبر فرض الشعائر الدينية، والتهديد بالجحيم، واستخدام سيف العقوق وربط الغضب الأبوي على أمور بسيطة بالغضب الرباني، ورواية قصص القبر والعذاب الأخروي بشكل أبكر من قدرة عقل الأطفال على الاستيعاب، ويندرج تحتها روايات التفكير السحري المبكرة: كقصص الجن، والحسد، والسحر، والأعمال وغيرها.
الإساءة الجنسية: كالتحرش المباشر بالطفل بالجسد أو باللفظ أو ربما بالنظر، أو الاستعراض الجسدي أمامه كالتعري، أو إهمال حدود الممارسة الجنسية بين الأبوين أمام الأبناء أو على مسامعهم، أو ردود الفعل المتخاذلة بعد رواية الأبناء لقصص تعرضهم للتحرش، أو تجريم الضحية، أو الأمر بالكتمان وتعميق الخزي، ويدخل كذلك تحت نطاق الإساءة الجنسية إخضاع البنات لعملية الختان (انتهاك الأعضاء التناسلية الأنثوية).
إن كل إساءة تحمل في تكويننا الأعمق أربعة أبعاد سنركز على تفصيلها: جرح الهجر، والخوف، والخزي، والاستياء.
![]()
- 1. جرح الهجر
إن الإنسان يتغير لسببين؛
حينما يتعلم أكثر مما يريد
أو حينما يتأذى أكثر مما يستحق.
شكسبير
كل إساءة هي (جرح هجر) وإن لم تحتوِ في حقيقتها على لفظ أو نبذ أو ابتعاد مكاني، ولكنها نزع للمرء من تربة أمانه، ومن بيئته الحاضنة.
والبيئة الحاضنة هي بيئة شعورية في حقيقتها وليست مجرد بيئة مكانية.
فكم من بيت لم يكن يظلنا سقفه وإن احتوى أجسادنا، وكم من منزل لم يكن يؤوينا في حقيقته وإن حاز اجسامنا، بل كنا نحتاج إيواءً من قسوة إيوائه.
لذا فالإساءة في حقيقتها هي نوع من الهجر؛ حيث تحمل البيئة الشعورية الحاضنة نفسها وترحل عنا، تتركنا الإساءة (عراة شعوريًّا)، (لاجئين نفسيًّا).
إن أهل الإساءة هم (أهل الهجر النفسي)، (المنفيون شعوريًّا)، لا يمكنهم أن يشعروا بالوطن في أي بقعة، ليس لأنهم قد اغتربوا عنه، ولكن الوطن هو من رحل عنهم!
وما الوطن بالنسبة لإنسان يتكون؟ هو ببساطة مساحة صغيرة من دائرة نصف قطرها الأيمن ذراع أبوي، والأيسر ثدي أموي، ومحيطها هو (حالة الاحتضان) الشعوري والجسدي لتهدئة خوف الصغير من عالم غريب ويهدده.
أي أن الأسرة ببساطة هي بيئة احتضان (تَهدَوِيَّة) لقلق مقابلة الوجود، يدخلها الإنسان لتحميه في البدايات لحين اكتمال نمو أدواته الخاصة التي يتمكن عبرها من مقابلة الوجود بشكل فعَّال وذاتي، هي ضرورة تطورية للطفل البشري (واحد من أطول الأطفال عمرًا في الطفولة والاعتمادية في المملكة الحيوانية بأسرها)، تمنحه بدائل مؤقتة لأدوات المواكبة التي لم تنشأ بعد فيه لمواجهة العالم، أي أنها ضرورة بقاء.
وغياب تلك البيئة لا يهدد بقاء الكائن في طفولته فقط، بل يُعطل من نمو أدوات التعامل مع العالم تلك، مما يهدد بقائه حتى بعد بلوغه أيضًا.
وهنا لا نتحدث عن التربية أو عن تعليم مهارات لهذا الطفل لكي يجابه العالم، فالطفل ليس لوحًا أبيض فارغًا يكتب فيه الأبوان والمجتمع الأول ما يشاء، فالأب والأم لا يعلمان ابنهما شيئًا في الحقيقة، إنما كأننا نتحدث عن (برعم) أو عن (بذرة) تحمل داخلها كافة إمكانات (الشجرة)، فقط تحتاج (التربة) خصبة وبعض السماد وماء الري لنمو تلك الإمكانات منها.
لا يمكننا أن نرى أن المحيط هو ما أنشأ أوراق تلك الشجرة، إنما فقط وفر لها ظروفًا مواتية وداعمة للنمو وميسرة له لا أكثر لتستخدمه الشجرة بتلك البرمجة الداخلية فيها لتنمو وتثمر وتصير أنموذجًا نهائيًّا للإمكان الموروث داخلها.
وغياب البيئة الداعمة للنمو والميسرة لتفعيل الإمكان، ماذا يفعل؟ يخرج نبتات شائهة، هذا لم تذبل وتنزوي وتموت.
فالنسر البالغ لا يعلم فراخه الطيران، إنما فقط يفعل إمكان الطيران المجبول عليه جينيًّا.
والأبوان لو لم يفعلا شيئًا سوى توفير الحب الصحي والقبول وكف أذاهما؛ لكان الناتج أفضل كثيرًا وأكثر راحة واتساقًّا داخليًّا من منتوجات المحاولة الشائهة للكتابة بالإساءة على لوح أبيض يظنان أنهما يمتلكانهَ!
الإساءة تقوم بتجميد النمو في مراحله النفسية الأولى، وتحرم الناشئ من تكوين جعبة أدواته لمواجهة العالم، لذا يخرج شاعرًا بالتهديد، وهو أكثر من ذلك التهديد الذي شعر به يوم أن جاء للعالم وعلم أن عليه مواجهة الوجود، فآوى إلى بيئة تمنحه أحتضانًا مؤقتًا لحين نمو أدواته، فلم يجد لديها سوى مزيد من التهديد والاغتراب.
لذا قد شعر الناشئ بنوع من التهديد المركب: (تهديد الوجود الأصلي) مضافًا إليه (تهديد هجر البيئة الحاضنة).
لذا يتخبط هذا الكائن المحروم من أدواته، مع خفقات القلب المرتعد داخله باحثًا عن تسكين لذلك التهديد، أو تلاه عنه.. فيبحث عن ذلك في العلاقات حينًا، وفي الانعزال المفرط حينًا، وفي السلطة حينًا، وفي الشهرة حينًا، بل وفي الإدمانات أحيانًا. فالإدمان ليس في حقيقته سوى محاولة هروب من ذلك (التهديد المركب) لشخص بلا أدوات لمواكبة الضغوط؛ الإدمان بكافة أشكاله: المخدرات، الكحول، الجنس، الإنفاق، العلاقات، الطعام، بل حتى تعاطي الدين نفسه كمحاولة تسكين للقلق المضاعف؛ هو نوع من المواكبة المغلوطة، أو ببساطة هو أدوات بالية لشخص يسير عاريًا في غابة الوجود؛ أدوات التقطها احتياجًا لا اختيارًا.
(البحث عن الكمالية): نفس الخصيصة النفسية والتي جعلتنا متفوقين ومميزين لفترة طويلة هي نفسها التي تعيقنا عن الوصول لتحقيق أقصى إمكاناتنا والوصول إلى ما يمكننا الوصول إليه، هي الحاجز عن قفزنا نحو ما يمكننا أن نكونه، والسبب في جعلنا مشلولين ومعطلين فيما نحن عليه، ومترددين قبل كل خطوة نخطوها.
* دعنا نفهم الأمر أكثر. وهو من الأهمية بمكان، بحيث أنه يمكننا أن نقول إن ذلك ما يقوم عليه آثار الإساءة في التكوين، وما ينبني عليه العمل في التعافي:
يمكننا أن نقول إن هناك أنواع من الشخصيات داخلنا تحوم في تجربتنا كلها تمثلنا: الأولى: هي ما نحن عليه الآن، أو يمكننا أن نقول إنها ذواتنا الحقيقية.. نعم، ولكنها ذاتنا الحقيقية غير المفعلة، الذات الحقيقية الخام، حد الكفاف من الشخصية. وهناك إمكانات دفينة فيها لو تم إرسالها للوجود وتحقيقها وتفعيلها لتحولنا نحو ما يمكن أن نكونه، أو دعنا نسميه (ذاتنا الحقيقية المفعلة)، أو (حد الإمكان من الذات الحقيقية).
ويكمن معنى وجود المرء في قبول ذاته الحقيقية والسعي في تحقيق إمكانها ليتحول عن حد الكفاف إلى حد الإمكان، ومن الذات الحقيقة المعطلة إلى الذات الحقيقية المفعلة!
أي أن الحياة تتمثل في حقيقتها بأنها سير من (الذات الحقيقية الخام) نحو (الذات الحقيقية المفعلة) في (مسار الاتساق مع الذات).
ولكن هناك المزيد من الشخصيات داخلنا، تحوم في تجربتنا وتعوق هذا التحول، فهناك ما يمكننا أن نسميه (الذات الزائفة)، وهي تلك الذات التي اخترعناها حين لم نحصل على الحب، فاخترعناها بغية الحصول عليه وبغية تلمس رضا الآخرين، الذات الاجتماعية التي صنعت مواءمات مع ما يريده الأهل، الذات مقلمة الأظافر التي ترتدي قناعًا اجتماعيًّا حربائيًّا يحاول حماية الذات الحقيقية من هجمات الرفض والنقد.
أي أننا ننشئ الذات الزائفة كمحاولة لحماية الذات الحقيقية من التهديد، وكأن اعتقادًا داخلنا يخبرنا أنه لو خرجت الذات الحقيقية للنور لهاجمها الآخرون حتى الأحبة منهم ورفضوها.
وبالتالي يكون عرض (الذات الحقيقة) والاتساق معها يحمل تهديدًا لها بالفناء، أي أن الذات الزائفة هي دفاع نفسي لا واعي أمام التهديد بالفناء المصاحب للاتساق مع الذات الحقيقة.
وبالتالي صار هناك نوع من الخوف الملازم للاتساق مع الذات.
وصار كل واحد منا يرى أن اتساقه مع نفسه يعني تخليه عن الذات المزيفة، وكأنه يخلف دروعه في معركة ويصير معرضًا لتلقي السهام.. سهام النقد والرفض والتهديد بالفناء لهذه الذات التي لا يقبلونها.
الذات المزيفة هي درعنا الاجتماعي! ولكن نظرًا لأننا ارتديناه طويلًا، فبشكل ما قد نسينا الذات الحقيقية وتطابقنا مع الذات المزيفة، وأصبحنا نُعرِّف أنفسنا من خلالها فحدث نوع من الاغتراب.
وهناك شخصية رابعة تحوم في تجربتنا، وهي الذات التي يريدنا المجتمع أن نصل إليها (الذات المزيفة المفروضة)، وهي ما يريده لنا الأهل ورجال الدين والأشخاص المؤثرون من المعلمين وغيرهم، وما يرونه لنا في مستقبلنا. وهي عبارة عن نهاية مسار (الذات الزائفة) وما يفترض عليها أن تصير عليه.
تلك الذات الزائفة المفروضة هي جماع لكل المفروضات، لكل (الينبغيات).. "ينبغي عليك أن تفعل كذا".
هي مجموع لكل القوالب والأحكام واللصقات الاجتماعية.
هي مجموع لكل المسارات المرسومة والطرق المستوردة التي قرر غيرنا أنه ينبغي علينا سلوكها.
هي ببساطة مجموع الواصفات القياسية التي تحاول مَيكَنة القوالب الاجتماعية أن تصنع الأفراد نسخًا منها!
إذن وكأننا أمام مسارين، وأربع ذوات.
المسار الحقيقي؛ مسار تحقيق الذات يبدأ من الذات الأصلية الحقيقية في حالة الكفاف والتعطيل، يتجه هذا المسار عبر تحقيق الإمكانات الأصيلة المخبوءة فينا، وينتهي عبر الذات الأصلية المفعلة في حالة الإمكان ويسمى مسار الاتساق مع النفس.
ومسار زائف؛ مسار الاغتراب عن الذات، يبدأ من الذات الزائفة كقناع اجتماعي للحماية ويتجه هذا المسار عبر عملية (المسخ النفسي) الذي يمارسه الأهل والمجتمع لينتهي عبر الذات الزائفة المفروضة.. [التي غالبًا لا نستطيع الوصول إليها أبدًا].
إما مسار الاتساق مع الذات، أو مسار الاغتراب عنها!
فهل هو اختيار؟!
في الحقيقة لا؛ فإنه كثير ما يتم دفعنا عنوة نحو مسار الاغتراب نتيجة التأثير فينا في مراحل نمونا الأولى وبراعمنا الهشة.
ولكن الخيار دومًا مطروح، يمكننا في أي لحظة أن نكسر دوامة مسار الاغتراب عن الذات ونعود لذواتنا الحقيقية، نتعرف عليها وعلى إمكانها الدفين، ونسلك مسار الاتساق!
ولكن ينبغي أن نعلم أنه حتى حين نقرر سلوك مسار الاتساق مع الذات والتعافي، تبقى لدينا (الكتالوجات الذهنية) وبرامج التشغيل التي تم زرعها فينا وبرمجتنا عليها، تبقى تزعجنا بطلباتها ومفروضاتها ومشاعر الذنب المتعلقة ببُعدنا عن هذا المفروض.
نبقى دومًا نحاول إرضاء (سلطات غير مرئية) داخلنا، وكأن كل أحمق قد مارس علينا سلطة يومًا وفرض (صنمّ) مصغرّ داخلنا نحاول تقديم القرابين له على الدوام.
أصبحت لدينا (لجنة منعقدة) داخل أدمغتنا تمثل كل هؤلاء السادة الذين طالبونا بأن نكون أو نفعل على أساس (مواصفات قياسية)، أصبحت هذه اللجنة (لجنة النقاد) الداخليين أو أحيانًا لا تكون فقط تحوي أعضاءً من النقاد بل من (الجلادين)، تُقيِّم أفعالنا وتزنها بموازين مستوردة، وتجلدنا وتصفعنا وتشعرنا بالذنب.
![]()
حوَّلنا الغضب كتوجه نحمله، فأصبحنا ناقمين على كل شيء أحيانًا، يملأ وجوهنا الامتعاض، لا شيء يعجبنا ولا شيء يمكن أن يرضينا.. نلعن الهاتف المتعطل، ونتذمر من حر الظهيرة بشكل يفوق المعتاد فقد تحملت الشمس بعض فاتورة الغضب الداخلية فينا، نثور عند كلمة عابرة وموقف بسيط!
ارتدينا ثوب (العصبية) والتأهب، صرنا سريعي الغضب كثيري التأفف ننتظر فرصة عابرة لتتفتح خزانات ثورتنا لتنصب لانفعالاتنا من ذلك الثقب الصغير في دفاعاتنا.
انصب الغضب حينًا على الأخوة الأصغر سنًّا، وحينًا على صديق، وحينًا على شريك الحياة، وحينًا على زملاء العمل، وبالأخص أولئك الذين لن يستطيعوا الدفاع بما يكفي، أي: أننا قمنا بتكرار المأساة؛ حيث صببنا صنوف العذاب والأزمات على أناس قد ساقهم حظهم العثر لطريقنا، تمامًا كما تم صب صنوف الألم علينا لأننا قد تقاطعت أقدارنا مع أناس كانت لهم السطوة على حياتنا وكانوا يحملون من العطب النفسي والتعثر ما فاضت أعراضه علينا دون جناية حقيقية منا، فقط وجودنا في المكان الخاطئ والوقت الخاطئ.
فكما تحولنا قديمًا (لكيس رمل) يفرِّغ فيه ذوو السلطة بؤسهم وإحباطاتهم، صرنا نحوِّل البعض دون وعي منا إلى (أكياس رمل) نفرغ فيها غضبنا المستور متخذين أعذارًا ومتصيدين للهفوات والأخطاء كذريعة لنفاذ استياءاتنا.
كل منا ببساطة كان يحمل طفلًا غاضبًا داخله لم يتم استرضاؤه يومًا، وكأنه تيبس في وضع الاستياء، وبدلًا من أن نلتفت نحوه ونمسح على غضبه ونخفف استياءه ونتعاطف مع جرحه الأصلي، تركناه يخرج منا في وضع الثورة ويتحكم فينا في نوبة هياج لا ينتج منها سوى الندم بعدها وخسارة العلاقات واحدة تلو الأخرى.
بل أحيانًا تحول الغضب نحو الوجود.. نحو الحياة.
نصبح غاضبين من الظروف والأقدار بشدة، نلومها على كل شيء، ونرجمها كلما مرت بنا مواقف محبطة أو عبرت بنا ذكرى تبعث على الاستياء.
وأحيانًا يتحول هذا الغضب تجاه الذات فيؤدي لمزيد من التعقيد حيث نقوم بمعاقبة أنفسنا وإيذائها بشتى الوسائل ونمارس نوعًا من الانتقام الذاتي. حيث يتطابق الجاني والضحية معًا. فنصبح نحن الضحايا ونحن الحكام، ونحن من نُوَقَّع العقوبة، ونحن أيضًا من نتلقاها!
هذه المحكمة الداخلية المعطوبة هي ما تحتاج للوقفة فنحرِّر أنفسنا من أقفاص الاتهام، ونعود لسماع صرخة الطفل الغاضب ونقبلها ونرى وجهتها الحقيقية ونتعاطف معه بما يكفي ليهدئ من ثورته ويستعيد رباطة جأشه ويواصل نموه المتعطل. بدلًا من أن ننمو حاملين هذا الطفل الغاضب داخلنا نتجاهله ولا نحترم وجعه، فيضطر أن يعلي من صراخه أكثر ويصب غضباته علينا وعلى الأحبة حولنا.
للاطلاع على الكتاب بأكمله:
https://bit.ly/40TNgyM
لمزيد من الاطلاع: